المشهد الإسرائيلي، بين الواقع والضلال القديم !
تم نشره الأربعاء 09 تشرين الثّاني / نوفمبر 2011 05:47 مساءً
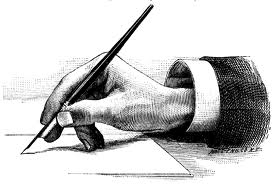
د. عادل محمد عايش الأسطل
تواصل حكومة (إسرائيل) التي يرأسها "بنيامين نتانياهو" سياساتها العدوانية، على الأراضي الفلسطينية وخاصة على قطاع غزة، من حيت حصارها الاقتصادي الخانق، ومواصلة عملياتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية، بقصد التخلص من أي شخصٍ، ممن تتوافر لديها معلومات عن نشاطاته وارتباطاته بحركات المقاومة الفلسطينية، وخاصةً الناشطة في تنفيذ عمليات ضد الأهداف (الإسرائيلية).
يأتي هذا العمل بلا شك، ضمن إطار خططها الخاصة، بما تسميه كسر الإرادة الفلسطينية، وطمس هويتها وتذويب مطالبها، من خلال تعنتها المقيت، القائم على نكران الحقوق الفلسطينية، والمستند إلى خلق واقع جديد، ومعتمدة على أسس تفتيت مناطق السلطة الوطنية. من خلال استمرار نشاطاتها الملحوظة لمشاريع إقامة المستوطنات على اختلاف تسمياتها، وذلك تنفيذاً لمقولات تاريخية ودينية مزعومة لإعمار "أرض إسرائيل" ويقابلها عمليات تدمير منظمة للبيوت والمؤسسات والمزارع الفلسطينية، تحت ذرائع مختلفة، أقلها ما تسميه السلطات الإسرائيلية بالقضايا الأمنية.
ومن جانب آخر، ما تقوم به (إسرائيل) وتخطط له حكومتها، من حيث استمرارية مسلسل الضغوطات والعقوبات المختلفة، على السلطة الفلسطينية، من أجل ما عرّفتها حكومتها مؤخراً، باتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات "انفرادية" باتجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، بهدف الاعتراف الأممي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، مما يعني لدى الجانب الإسرائيلي، تجنب السلطة الفلسطينية، مسألة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بهدف العمل على الوصول إلى تسوية حول القضايا، دون لجوء السلطة إلى اتخاذ خطوات انفرادية تكون (إسرائيل) غير راضية عنها.
وكانت (إسرائيل) قد غاب عن بالها، بأن قضية الجلوس إلى طاولة المفاوضات كما تريد، وفي ضوء تنامي النشاطات الاستيطانية، تبدو غير مقبولة لدى الفلسطينيين أو العرب بوجه عام، خاصةً حين أيّد وزراء الخارجية العرب الموقف الفلسطيني، بعدم إجراء المزيد من المفاوضات مع الإسرائيليين، إلاّ في حال توقف النشاط الاستيطاني، وزاد الأمر تعقيداً، لا سيما في ظل الظروف الآنية الصعبة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والناجمة عن حرب "نتانياهو" الشاملة والمعقدة، ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية. كما أن الضغط الإسرائيلي، لحصر المطالب الفلسطينية في مسائل تضعها إسرائيل في مقابل عِداد القضايا التي تقضي بتأمين المتطلبات التعجيزية الإسرائيلية، والتي بالمرّة لا تلبِ أي نوعٍ من المطالب الفلسطينية بصورةٍ معقولة، أو يمكن قبولها لدى الشعب الفلسطيني، هذا الضغط، لم ولن يحظَ لدى الفلسطينيين بأي اهتمام، لأن أي أمر يبتعد عن تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، أساسية كانت أم فرعية، من شأنه أن يجعل أية حلول بعيدةً عن العدل والإنصاف، اللذان يفترض أن يحكمان أسس التوصل إلي حلول مقنعة، لجملة عوامل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ففي ظل المستوي المتدني الراهن للعلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية، وفي ظل اليد العليا الإسرائيلية، تلجأ (إسرائيل) وكما درجت عليه في كل مرة، إلى تعليق الخلل الشمولي ومسببات تراجع العلاقات بين الطرفين، على شماعة عدم وجود نيّة للحلحلة من قبل الجانب الفلسطيني، وترقى إلى عدم وجود شريك فلسطيني، لأنه الرافض لإحداث نوعٍ من الليونة في مواقفه، ويضع شروطاً هي في نظرها - تعجيزية- وهي توقف الاستيطان في الضفة الغربية وخاصةً في القدس الشرقية، بالرغم من أن المجتمع الدولي بما فيه الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة، تدرج إلى منحى القبول بالرؤية الفلسطينية، وتنتقد (إسرائيل) جهاراً نهاراً في هذا الجانب، وتعتبر عملية استمرارها بمواصلة الاستيطان، بأنها مقلقة، وهي تمثل سبباً مهماً في عدم عودة الجانب الفلسطيني، لمائدة المفاوضات بل وتعتبرها عقبة في طريق التوصل إلى سلام دائم وشامل، وبرغم ذلك لا تكف (إسرائيل) عن اتهام السلطة الفلسطينية، بعدم اهتمامها بالسعي إلى التوصل إلى اتفاق سلام.
بعد العمليات الإسرائيلية الأخيرة في القطاع، كان واضحاً أن القيادة الإسرائيلية، لم تعد تخجل من الكلام عن الحرب، والتي تلطّف من تسميتها بالعمليات العسكرية لتنظيف القطاع من المسلحين الفلسطينيين، أو غيرها من التسميات، وخاصةً حين حذر" آفي ديختر" وهو نائب إسرائيلي من (كاديما) ورئيس جهاز "الشاباك" السابق، من أن (إسرائيل) قد تضطر إلى احتلال غزة من جديد، لتفكيك البني التحتية فيها، في حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي آخر بمشاركة الدول المجاورة، ولا ندري من هي الدول المجاورة التي يقصدها "ريختر"، جاء هذا التحذير وغيره، في ظل الربيع العربي وخاصة التغير الحاصل في الدولة الكبرى (مصر) التي دعت الفصائل الفلسطينية إلى الحفاظ على التهدئة، محذرًة من أن أي تصعيد آخر من قطاع غزة، سيؤدي إلى شن (إسرائيل) عملية عسكرية ضد القطاع. ورد ذلك لأسباب سياسية خالصة، وهي تعلم أن (إسرائيل) كما تعلم (إسرائيل) نفسها، أنها لا تستطيع تجاهلها بسهولة، لكنها في الوقت الذي نراها ويراها الجميع تنخرط في سياسة عدوانية استعمارية كريهة، تعيد للأذهان ذكريات الاحتلال الصهيوني منذ بداياته، بدءاً بعمليات التنكيل والتهجير ومروراً بالسياسات القمعية، في طول وعرض الشعب الفلسطيني، وانتهاءً بما هو حاصل الآن من حصار وعقوبات وحرب لا هوادة فيها.
من أجل ذلك، كان لا بد من اتخاذ الخطوات التي تم اتخاذها من قبل السلطة الفلسطينية، من إعادة لصياغة العلاقات التفاعلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علي أسس هي غير الأسس السائدة، بل على أسس معاكسة تماماً لما كان حاصلاً في الماضي، نظراً لواقع الحياة اليومية المعاشة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً بين الطرفين. بل بالإمكان إضافة، ضرورة اتخاذ مسارات من شأنها التكثير من الهيبة الفلسطينية، والتقليل من الخسائر، ولو أدى ذلك إلى توقيف أو تأجيل الحديث عن مفاوضات السلام، وحتى عن السلام نفسه، حتى تكون هناك تهيئة مواتية من جانب (إسرائيل)، يكون سببها، اقتناعها بمقدرة الأمة العربية من استرجاع قواها من جديد، لتفرض عليها الإذعان للمطالب العربية والفلسطينية، ومنها وقف الاستيطان بكل أشكاله، واستعدادها للتماشي مع الطموحات الفلسطينية، حسب قرارات الأمم المتحدة والتفاهمات المتفق عليها، إذا ما أرادت (إسرائيل) أن تصل لعلاقات أفضل بهدف استمرارية وجودها - ولو إلى أجل - وإذا ما أرادت لعملية السلام أن تستمر، وفق سياقات مقبولة على الواقع العربي والفلسطيني، وليس على ما تفرضه الوقائع الإسرائيلية.
قبل أيام، وفي غمرة النشاط الدبلوماسي المكثف في الجانب الفلسطيني، لدى المنظمات الدولية والدول الرسمية، حيث تنقل الرئيس الفلسطيني بينها، في غمرة هذا النشاط، كان يقابله تصريحات عدائية وإجراءات عقابية مختلفة، بدأتها الولايات المتحدة وتبعتها (إسرائيل) لتكون أكثر نشاطاً في هذا الجانب، وهي كثيرة ومنها، فإلى جانب العمليات الاستيطانية والتهويدية، والعمليات العدوانية العسكرية على مدار الساعة، واحتجاز أموال السلطة، واستمرار الحصار سنةً بعد أخرى، والقبض على المتضامنين في عرض البحر، والاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فهي أيضاً تقوم بين الدول بالترغيب والترهيب من أن يساندوا الفلسطينيين سواءً بطريق مباشر أو بطريق دعمهم في المحافل الدولية المختلفة.
وبالرغم من كل ذلك فإن المعادلة السياسية الراهنة لدى الفلسطينيين تفيد، باستعداد السلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات واستعادة عملية السلام، وفق المرجعيات المطروحة بضمنها مبادرة السلام العربية وفكرة خارطة الطريق، مع استعداد للتعامل مع مقترحات دولية وعربية. لكن يقابل ذلك علي الجانب (الإسرائيلي) حكومة "يمينية" متطرفة، لا تملك أي منهج للسلام، وتتشبث بالاستمرارية خلف القضايا الأمنية، وفق خطة عسكرية قائمة على أساس الحرب ضد الشعب الفلسطيني، والالتفاف على مقررات أوسلو، وما تبعها من اتفاقات وتفاهمات حول العديد من القضايا، وإن كانت من ذوات القشور، وفي الوقت نفسه طرح أفكار حول حلول مرحلية مع الفلسطينيين، مع إغفال تام للحديث عن السلام مع الحركات والتنظيمات السياسية الأخرى، خاصةً حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وسط هذا الكم من التناقضات والتباينات بين الجانبين، يجري الحديث عن إمكانية عودة الطرفين إلى المفاوضات، بتدخل من الرباعية الدولية – المنتهية الصلاحية- بهدف التقريب بين وجهات النظر، وعلى خلفية المرجعيات المألوفة، والتي كانت عقدت اجتماعاً في المنطقة، في أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي، لكن دون اختراقات تذكر، اللهم من التوصل إلى تقديم كل طرف مقترحات تهدف إلى مواصلة المفاوضات، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. وهذه في حد ذاتها، لا تُعد إنجازاً ولا شيئاً ذا بال، ولكن إذا ما سلّمنا بشيءٍ من ذلك، فماذا بعد؟ بل ماذا قبل؟ ونحن نعلم أن القيادة في (إسرائيل) كل يوم هي في شأن. سواء من ناحية الإضرابات الشاملة التي تشل حركتها في الداخل، أو ما يشغلها خارجياً وهو الملف النووي الإيراني، فهذه الأمور وغيرها، تؤرق (إسرائيل) ومازالت تضعها في قلق أكبر، وخاصةً من حيث أن زوال القلق الوارد منها، هو لا يزال في علم الغيب.
إن فكرة تشغيل الرباعية في هذه القضية، وفي هذه المرحلة بالذات، تبدو فكرة غير جذابة، بالرغم من أنها كانت تبحث أفكاراً على خلفية حل الدولتين، كانت تطرح هنا وهناك، لكنها في النهاية كانت تظل في عداد الافتراضات، الغير قابلة للتنفيذ من كلا الجانبين، وإن كان الجانب الإسرائيلي هو الأبعد، الأمر الذي جعل الرباعية، تبتعد أكثر عن التصور الحقيقي لما جري ويجري علي الأرض، وأصبحت محاطة باتهام الفلسطينيين بإغفالها المطالب الفلسطينية المهمة وتماهيها مع المطالب الإسرائيلية من جانب، والملاحظات الإسرائيلية المتعددة على مقرراتها أو توصياتها من جانب آخر. صحيح أنها كانت أفكار نابعة عن خبرة في شؤون الشرق الأوسط، وتجارب ميدانية مع قياداته السياسية، وربما معرفةً بالكثير من كواليس العمل السياسي على مستوى المنطقة، إلاّ أنها بالتأكيد كانت بعيدة عما خلفه واقع الحال، الدائر بين الطرفين، الذي اتسم بالقوة الإرهابية والحرب الغير متكافئة، من منطق تعايش قائم على أساس العداء المتبادل، وبالوسائل التي يحوزها كل طرف، وما أبعدها أكثر هو السلوك الغير موضوعي، من قبل مبعوث اللجنة الرباعية "توني بلير" الذي أوضح، أنه لن يكون هناك اتفاق ما دام (عباس) هو رئيس السلطة الفلسطينية. الأمر الذي اعتبرته جهات عربية وفلسطينية، بأنه "توني بلير" يفتقد إلى النزاهة والمصداقية.
إذاً وكما يبدو، فلن يكون بمقدور الرباعية، الوصول إلى أي آلية من شأنها تحريك الوضع على نحو صورةٍ مرضية لكلا الطرفين، وحتى في الأمور الثانوية، وهذا هو الرأي الراجح لدى الكثيرين من الساسة والمحللين وأصحاب القرار. على أن، وفي زمن مضى، كان السائد على رأي الكثيرين، ومنهم خبراء وقادة سابقين وخاصةً في الإدارة الأمريكية، يظهرون أفكاراً مفادها، أنه إذا ما أُريد الحل، فإنه يتوجب على الولايات المتحدة وهي "القادرة" أن تضع أمام الطرفين حلاً نهائياً، يوضح حدود مناطق كل دولة. ولدعم هذا الحل ينبغي إقناع الدول العربية، للضغط على الفلسطينيين، بضرورة تغيير شكل المنطقة عموماً ليتسنَ قبول الحل الأمريكي، ومن ناحيةٍ أخرى، وضع قوات أمريكية علي الأرض، لتهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية الحقيقية.
هذه الفكرة تبدو مقبولة لدى الجانب الإسرائيلي، وبالطبع مع العديد من الملاحظات، إلاّ أنها من الصعب أن تنال رضا الجانب الفلسطيني، لعلة إدراك الفلسطينيين بعدم نزاهة الجانب "الراعي" الأمريكي، الذي يحرص تمام الحرص على (إسرائيل) وأمنها ومستقبلها- سياسياً وأخلاقياً ودينياً وهو الأهم- ويتغاضى عن متطلبات الجانب العربي والفلسطيني، وكل ما يهتم باستقرار المنطقة.
أما الآن، وبعد تفاقم الأمور إلى أبعد حد، وإذا كانت السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع يسمح لها بالتفاوض، ودراسة الأفكار المطروحة كافة، انطلاقاً من حرصها علي تأكيد رغبتها في السلام، وذلك إذا ما تم وقف الاستيطان تماماً، فإن ثمة أوساطاً وتنظيمات معارضة فلسطينية، لا تزال لا تقبل بالتنازل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهناك من يذهب إلي أبعد من ذلك بكثير، مثلما يوجد على الجانب الإسرائيلي، من يرفض إعادة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وخاصة من المتشددين الدينيين، الذين يشاركون "نتانياهو" حكومته، والذين يقولون بحرمة التنازل عن "أرض إسرائيل" وهم بذلك يعبرون في واقع الحال عما تبطنه الحكومة، وفي كل الوقت.
عموماً، فإن الأفكار الإسرائيلية وحتى الدولية المطروحة، والتي طُرحت منذ الماضي، لبلورة ملامح الحل النهائي، بدت دائماً وأبداً، دون مستوى المطالب الفلسطينية بكثير، التي كان يرفضها الجانب الفلسطيني بجملتها وفي كل مرة، وخاصةً في ظل تغوّل الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أوصل الجانب الإسرائيلي، بإدخال عامل التلويح بضرورة التخلص من الرئيس "أبومازن" كما ورد على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي"أفيغدور ليبرمان" حين أعلن بأن الرئيس عباس، عقبة في طريق السلام، وأنه يجب إزاحته عن الساحة التفاوضية للوصول إلى السلام، جاء ذلك للاعتقاد العام، كعامل ضغط على الجانب الفلسطيني، للاقتراب مما هو مطروح – إسرائيلياً- على الساحة السياسية الدولية، لتمرير مثل هذه الأفكار الخاصة بالحل النهائي.
الفلسطينيون بالمقابل لهم تصورهم وقراءتهم لقضايا الحل النهائي، والمستمد في أغلبه من الجانب العربي، الذي وضع مبادرة السلام العربية علي طاولة التفاوض، خلال قمة بيروت في العام 2002، والتي تبين من خلالها، المدى الأقصى الذي يمكن أن يذهب إليه العرب، على طريق السلام العربي- الإسرائيلي، بالرغم من أن كانت هناك ثمة تحفظات، لدى دولٍ عربية واضحة منذ البداية، التي كانت بمثابة أرضية مهمة، لتزداد وتيرتها شدةً، تبعاً للأحداث والسلوكيات الإسرائيلية العدوانية تجاه الفلسطينيين بخاصة، ولكنها لم تصل إلى حد التخلي عن المبادرة أو إلغائها، بالرغم من عدم التفات الجانب الإسرائيلي لها منذ طرحها. أما بالنسبة لمآل الجهود الدولية الأخرى، فقد ذهبت أدراج الرياح، ولم يُعتدّ بها أو يُلتفت إلها، وإن كانت مكثفة، على أمل الخروج بحل نهائي قائم علي أساس، نوايا إسرائيلية صادقة، لكن ما حصل هو العكس.
إن استعادة عملية السلام في الشرق الأوسط لدى السلطة الفلسطينية الآن، لا يبدو أمراً مهماً في هذه المرحلة بالذات. خاصة في ظل استمرار الاستيطان وزيادة وتيرته، ومن ناحية أخرى سعيها نحو الأمم المتحدة، لكسب التأييد لدى منظماتها بالاعتراف بها كدولة.
لكن إذا ما تهيّأت الظروف كاملةً، لمواصلة العملية التفاوضية، القصد منها التوصل إلي حل نهائي وشامل، فيجب إن يؤخذ بالاعتبار رضا الجانب الفلسطيني في جميع مطالبه، إما أن يبقي الضغط الدولي مسلطاً على الطرف الأضعف، وهم الفلسطينيون والعرب، وتُوجّه لقادتهم تُهم العقبة في وجه السلام، وأخرى للمقاومة تتعلق بالإرهاب، فهذه لن تحسم الخلافات القائمة، مهما كانت دقة العمليات التجميلية للفكرة التفاوضية، وسيظل كل شيء يُراوح مكانه، لأن القضية بالنسبة للفلسطينيين والعرب، هي إنهاء الاحتلال والقضاء على إرهاب المحتل.
لكن وكما يبدو وفي ظل حكومة إسرائيلية يمينية، وضعت قضية السلام في آخر سلم أولوياتها، فإن الأمر يستلزم، وقفة جادة أولاً من قبل المجتمع الفلسطيني، لإنهاء حالة الانقسام، ومن ثم التطلع إلى الدور العربي القادم، الذي من شأنه لملمة الجهود، التي ترمي إلى تنشيط الدور الدولي وخاصةً الولايات المتحدة، باعتبارها الطرف الأكثر فاعلية في التأثير، وفرض الحل على الطرف الإسرائيلي، ليس من قبيل احترامها للعرب وتأييدها للفلسطينيين، ولكن لأجل مصالحها المصيرية، وسواء الحالية أو المستقبلية، أما أن تظل المخاوف الأمنية الإسرائيلية "الأكاذيب" هي المسيطرة طوال الوقت، وتُهمل المطالب الفلسطينية، إسرائيلياً وأمريكياً، فذلك لن يزيد الأمر إلاّ تعقيداً، وتكريساً للصراع، وعندها لن يثنِ من عقد العزم على مقاومة الاحتلال بصوره ومعانيه، عن أن يظل يقاوم عدواً، لا يدفع الحق إلاّ حتف أنفه، وإن طال الزمن.
يأتي هذا العمل بلا شك، ضمن إطار خططها الخاصة، بما تسميه كسر الإرادة الفلسطينية، وطمس هويتها وتذويب مطالبها، من خلال تعنتها المقيت، القائم على نكران الحقوق الفلسطينية، والمستند إلى خلق واقع جديد، ومعتمدة على أسس تفتيت مناطق السلطة الوطنية. من خلال استمرار نشاطاتها الملحوظة لمشاريع إقامة المستوطنات على اختلاف تسمياتها، وذلك تنفيذاً لمقولات تاريخية ودينية مزعومة لإعمار "أرض إسرائيل" ويقابلها عمليات تدمير منظمة للبيوت والمؤسسات والمزارع الفلسطينية، تحت ذرائع مختلفة، أقلها ما تسميه السلطات الإسرائيلية بالقضايا الأمنية.
ومن جانب آخر، ما تقوم به (إسرائيل) وتخطط له حكومتها، من حيث استمرارية مسلسل الضغوطات والعقوبات المختلفة، على السلطة الفلسطينية، من أجل ما عرّفتها حكومتها مؤخراً، باتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات "انفرادية" باتجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، بهدف الاعتراف الأممي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، مما يعني لدى الجانب الإسرائيلي، تجنب السلطة الفلسطينية، مسألة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بهدف العمل على الوصول إلى تسوية حول القضايا، دون لجوء السلطة إلى اتخاذ خطوات انفرادية تكون (إسرائيل) غير راضية عنها.
وكانت (إسرائيل) قد غاب عن بالها، بأن قضية الجلوس إلى طاولة المفاوضات كما تريد، وفي ضوء تنامي النشاطات الاستيطانية، تبدو غير مقبولة لدى الفلسطينيين أو العرب بوجه عام، خاصةً حين أيّد وزراء الخارجية العرب الموقف الفلسطيني، بعدم إجراء المزيد من المفاوضات مع الإسرائيليين، إلاّ في حال توقف النشاط الاستيطاني، وزاد الأمر تعقيداً، لا سيما في ظل الظروف الآنية الصعبة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والناجمة عن حرب "نتانياهو" الشاملة والمعقدة، ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية. كما أن الضغط الإسرائيلي، لحصر المطالب الفلسطينية في مسائل تضعها إسرائيل في مقابل عِداد القضايا التي تقضي بتأمين المتطلبات التعجيزية الإسرائيلية، والتي بالمرّة لا تلبِ أي نوعٍ من المطالب الفلسطينية بصورةٍ معقولة، أو يمكن قبولها لدى الشعب الفلسطيني، هذا الضغط، لم ولن يحظَ لدى الفلسطينيين بأي اهتمام، لأن أي أمر يبتعد عن تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، أساسية كانت أم فرعية، من شأنه أن يجعل أية حلول بعيدةً عن العدل والإنصاف، اللذان يفترض أن يحكمان أسس التوصل إلي حلول مقنعة، لجملة عوامل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ففي ظل المستوي المتدني الراهن للعلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية، وفي ظل اليد العليا الإسرائيلية، تلجأ (إسرائيل) وكما درجت عليه في كل مرة، إلى تعليق الخلل الشمولي ومسببات تراجع العلاقات بين الطرفين، على شماعة عدم وجود نيّة للحلحلة من قبل الجانب الفلسطيني، وترقى إلى عدم وجود شريك فلسطيني، لأنه الرافض لإحداث نوعٍ من الليونة في مواقفه، ويضع شروطاً هي في نظرها - تعجيزية- وهي توقف الاستيطان في الضفة الغربية وخاصةً في القدس الشرقية، بالرغم من أن المجتمع الدولي بما فيه الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة، تدرج إلى منحى القبول بالرؤية الفلسطينية، وتنتقد (إسرائيل) جهاراً نهاراً في هذا الجانب، وتعتبر عملية استمرارها بمواصلة الاستيطان، بأنها مقلقة، وهي تمثل سبباً مهماً في عدم عودة الجانب الفلسطيني، لمائدة المفاوضات بل وتعتبرها عقبة في طريق التوصل إلى سلام دائم وشامل، وبرغم ذلك لا تكف (إسرائيل) عن اتهام السلطة الفلسطينية، بعدم اهتمامها بالسعي إلى التوصل إلى اتفاق سلام.
بعد العمليات الإسرائيلية الأخيرة في القطاع، كان واضحاً أن القيادة الإسرائيلية، لم تعد تخجل من الكلام عن الحرب، والتي تلطّف من تسميتها بالعمليات العسكرية لتنظيف القطاع من المسلحين الفلسطينيين، أو غيرها من التسميات، وخاصةً حين حذر" آفي ديختر" وهو نائب إسرائيلي من (كاديما) ورئيس جهاز "الشاباك" السابق، من أن (إسرائيل) قد تضطر إلى احتلال غزة من جديد، لتفكيك البني التحتية فيها، في حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي آخر بمشاركة الدول المجاورة، ولا ندري من هي الدول المجاورة التي يقصدها "ريختر"، جاء هذا التحذير وغيره، في ظل الربيع العربي وخاصة التغير الحاصل في الدولة الكبرى (مصر) التي دعت الفصائل الفلسطينية إلى الحفاظ على التهدئة، محذرًة من أن أي تصعيد آخر من قطاع غزة، سيؤدي إلى شن (إسرائيل) عملية عسكرية ضد القطاع. ورد ذلك لأسباب سياسية خالصة، وهي تعلم أن (إسرائيل) كما تعلم (إسرائيل) نفسها، أنها لا تستطيع تجاهلها بسهولة، لكنها في الوقت الذي نراها ويراها الجميع تنخرط في سياسة عدوانية استعمارية كريهة، تعيد للأذهان ذكريات الاحتلال الصهيوني منذ بداياته، بدءاً بعمليات التنكيل والتهجير ومروراً بالسياسات القمعية، في طول وعرض الشعب الفلسطيني، وانتهاءً بما هو حاصل الآن من حصار وعقوبات وحرب لا هوادة فيها.
من أجل ذلك، كان لا بد من اتخاذ الخطوات التي تم اتخاذها من قبل السلطة الفلسطينية، من إعادة لصياغة العلاقات التفاعلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علي أسس هي غير الأسس السائدة، بل على أسس معاكسة تماماً لما كان حاصلاً في الماضي، نظراً لواقع الحياة اليومية المعاشة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً بين الطرفين. بل بالإمكان إضافة، ضرورة اتخاذ مسارات من شأنها التكثير من الهيبة الفلسطينية، والتقليل من الخسائر، ولو أدى ذلك إلى توقيف أو تأجيل الحديث عن مفاوضات السلام، وحتى عن السلام نفسه، حتى تكون هناك تهيئة مواتية من جانب (إسرائيل)، يكون سببها، اقتناعها بمقدرة الأمة العربية من استرجاع قواها من جديد، لتفرض عليها الإذعان للمطالب العربية والفلسطينية، ومنها وقف الاستيطان بكل أشكاله، واستعدادها للتماشي مع الطموحات الفلسطينية، حسب قرارات الأمم المتحدة والتفاهمات المتفق عليها، إذا ما أرادت (إسرائيل) أن تصل لعلاقات أفضل بهدف استمرارية وجودها - ولو إلى أجل - وإذا ما أرادت لعملية السلام أن تستمر، وفق سياقات مقبولة على الواقع العربي والفلسطيني، وليس على ما تفرضه الوقائع الإسرائيلية.
قبل أيام، وفي غمرة النشاط الدبلوماسي المكثف في الجانب الفلسطيني، لدى المنظمات الدولية والدول الرسمية، حيث تنقل الرئيس الفلسطيني بينها، في غمرة هذا النشاط، كان يقابله تصريحات عدائية وإجراءات عقابية مختلفة، بدأتها الولايات المتحدة وتبعتها (إسرائيل) لتكون أكثر نشاطاً في هذا الجانب، وهي كثيرة ومنها، فإلى جانب العمليات الاستيطانية والتهويدية، والعمليات العدوانية العسكرية على مدار الساعة، واحتجاز أموال السلطة، واستمرار الحصار سنةً بعد أخرى، والقبض على المتضامنين في عرض البحر، والاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فهي أيضاً تقوم بين الدول بالترغيب والترهيب من أن يساندوا الفلسطينيين سواءً بطريق مباشر أو بطريق دعمهم في المحافل الدولية المختلفة.
وبالرغم من كل ذلك فإن المعادلة السياسية الراهنة لدى الفلسطينيين تفيد، باستعداد السلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات واستعادة عملية السلام، وفق المرجعيات المطروحة بضمنها مبادرة السلام العربية وفكرة خارطة الطريق، مع استعداد للتعامل مع مقترحات دولية وعربية. لكن يقابل ذلك علي الجانب (الإسرائيلي) حكومة "يمينية" متطرفة، لا تملك أي منهج للسلام، وتتشبث بالاستمرارية خلف القضايا الأمنية، وفق خطة عسكرية قائمة على أساس الحرب ضد الشعب الفلسطيني، والالتفاف على مقررات أوسلو، وما تبعها من اتفاقات وتفاهمات حول العديد من القضايا، وإن كانت من ذوات القشور، وفي الوقت نفسه طرح أفكار حول حلول مرحلية مع الفلسطينيين، مع إغفال تام للحديث عن السلام مع الحركات والتنظيمات السياسية الأخرى، خاصةً حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وسط هذا الكم من التناقضات والتباينات بين الجانبين، يجري الحديث عن إمكانية عودة الطرفين إلى المفاوضات، بتدخل من الرباعية الدولية – المنتهية الصلاحية- بهدف التقريب بين وجهات النظر، وعلى خلفية المرجعيات المألوفة، والتي كانت عقدت اجتماعاً في المنطقة، في أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي، لكن دون اختراقات تذكر، اللهم من التوصل إلى تقديم كل طرف مقترحات تهدف إلى مواصلة المفاوضات، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. وهذه في حد ذاتها، لا تُعد إنجازاً ولا شيئاً ذا بال، ولكن إذا ما سلّمنا بشيءٍ من ذلك، فماذا بعد؟ بل ماذا قبل؟ ونحن نعلم أن القيادة في (إسرائيل) كل يوم هي في شأن. سواء من ناحية الإضرابات الشاملة التي تشل حركتها في الداخل، أو ما يشغلها خارجياً وهو الملف النووي الإيراني، فهذه الأمور وغيرها، تؤرق (إسرائيل) ومازالت تضعها في قلق أكبر، وخاصةً من حيث أن زوال القلق الوارد منها، هو لا يزال في علم الغيب.
إن فكرة تشغيل الرباعية في هذه القضية، وفي هذه المرحلة بالذات، تبدو فكرة غير جذابة، بالرغم من أنها كانت تبحث أفكاراً على خلفية حل الدولتين، كانت تطرح هنا وهناك، لكنها في النهاية كانت تظل في عداد الافتراضات، الغير قابلة للتنفيذ من كلا الجانبين، وإن كان الجانب الإسرائيلي هو الأبعد، الأمر الذي جعل الرباعية، تبتعد أكثر عن التصور الحقيقي لما جري ويجري علي الأرض، وأصبحت محاطة باتهام الفلسطينيين بإغفالها المطالب الفلسطينية المهمة وتماهيها مع المطالب الإسرائيلية من جانب، والملاحظات الإسرائيلية المتعددة على مقرراتها أو توصياتها من جانب آخر. صحيح أنها كانت أفكار نابعة عن خبرة في شؤون الشرق الأوسط، وتجارب ميدانية مع قياداته السياسية، وربما معرفةً بالكثير من كواليس العمل السياسي على مستوى المنطقة، إلاّ أنها بالتأكيد كانت بعيدة عما خلفه واقع الحال، الدائر بين الطرفين، الذي اتسم بالقوة الإرهابية والحرب الغير متكافئة، من منطق تعايش قائم على أساس العداء المتبادل، وبالوسائل التي يحوزها كل طرف، وما أبعدها أكثر هو السلوك الغير موضوعي، من قبل مبعوث اللجنة الرباعية "توني بلير" الذي أوضح، أنه لن يكون هناك اتفاق ما دام (عباس) هو رئيس السلطة الفلسطينية. الأمر الذي اعتبرته جهات عربية وفلسطينية، بأنه "توني بلير" يفتقد إلى النزاهة والمصداقية.
إذاً وكما يبدو، فلن يكون بمقدور الرباعية، الوصول إلى أي آلية من شأنها تحريك الوضع على نحو صورةٍ مرضية لكلا الطرفين، وحتى في الأمور الثانوية، وهذا هو الرأي الراجح لدى الكثيرين من الساسة والمحللين وأصحاب القرار. على أن، وفي زمن مضى، كان السائد على رأي الكثيرين، ومنهم خبراء وقادة سابقين وخاصةً في الإدارة الأمريكية، يظهرون أفكاراً مفادها، أنه إذا ما أُريد الحل، فإنه يتوجب على الولايات المتحدة وهي "القادرة" أن تضع أمام الطرفين حلاً نهائياً، يوضح حدود مناطق كل دولة. ولدعم هذا الحل ينبغي إقناع الدول العربية، للضغط على الفلسطينيين، بضرورة تغيير شكل المنطقة عموماً ليتسنَ قبول الحل الأمريكي، ومن ناحيةٍ أخرى، وضع قوات أمريكية علي الأرض، لتهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية الحقيقية.
هذه الفكرة تبدو مقبولة لدى الجانب الإسرائيلي، وبالطبع مع العديد من الملاحظات، إلاّ أنها من الصعب أن تنال رضا الجانب الفلسطيني، لعلة إدراك الفلسطينيين بعدم نزاهة الجانب "الراعي" الأمريكي، الذي يحرص تمام الحرص على (إسرائيل) وأمنها ومستقبلها- سياسياً وأخلاقياً ودينياً وهو الأهم- ويتغاضى عن متطلبات الجانب العربي والفلسطيني، وكل ما يهتم باستقرار المنطقة.
أما الآن، وبعد تفاقم الأمور إلى أبعد حد، وإذا كانت السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع يسمح لها بالتفاوض، ودراسة الأفكار المطروحة كافة، انطلاقاً من حرصها علي تأكيد رغبتها في السلام، وذلك إذا ما تم وقف الاستيطان تماماً، فإن ثمة أوساطاً وتنظيمات معارضة فلسطينية، لا تزال لا تقبل بالتنازل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهناك من يذهب إلي أبعد من ذلك بكثير، مثلما يوجد على الجانب الإسرائيلي، من يرفض إعادة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وخاصة من المتشددين الدينيين، الذين يشاركون "نتانياهو" حكومته، والذين يقولون بحرمة التنازل عن "أرض إسرائيل" وهم بذلك يعبرون في واقع الحال عما تبطنه الحكومة، وفي كل الوقت.
عموماً، فإن الأفكار الإسرائيلية وحتى الدولية المطروحة، والتي طُرحت منذ الماضي، لبلورة ملامح الحل النهائي، بدت دائماً وأبداً، دون مستوى المطالب الفلسطينية بكثير، التي كان يرفضها الجانب الفلسطيني بجملتها وفي كل مرة، وخاصةً في ظل تغوّل الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أوصل الجانب الإسرائيلي، بإدخال عامل التلويح بضرورة التخلص من الرئيس "أبومازن" كما ورد على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي"أفيغدور ليبرمان" حين أعلن بأن الرئيس عباس، عقبة في طريق السلام، وأنه يجب إزاحته عن الساحة التفاوضية للوصول إلى السلام، جاء ذلك للاعتقاد العام، كعامل ضغط على الجانب الفلسطيني، للاقتراب مما هو مطروح – إسرائيلياً- على الساحة السياسية الدولية، لتمرير مثل هذه الأفكار الخاصة بالحل النهائي.
الفلسطينيون بالمقابل لهم تصورهم وقراءتهم لقضايا الحل النهائي، والمستمد في أغلبه من الجانب العربي، الذي وضع مبادرة السلام العربية علي طاولة التفاوض، خلال قمة بيروت في العام 2002، والتي تبين من خلالها، المدى الأقصى الذي يمكن أن يذهب إليه العرب، على طريق السلام العربي- الإسرائيلي، بالرغم من أن كانت هناك ثمة تحفظات، لدى دولٍ عربية واضحة منذ البداية، التي كانت بمثابة أرضية مهمة، لتزداد وتيرتها شدةً، تبعاً للأحداث والسلوكيات الإسرائيلية العدوانية تجاه الفلسطينيين بخاصة، ولكنها لم تصل إلى حد التخلي عن المبادرة أو إلغائها، بالرغم من عدم التفات الجانب الإسرائيلي لها منذ طرحها. أما بالنسبة لمآل الجهود الدولية الأخرى، فقد ذهبت أدراج الرياح، ولم يُعتدّ بها أو يُلتفت إلها، وإن كانت مكثفة، على أمل الخروج بحل نهائي قائم علي أساس، نوايا إسرائيلية صادقة، لكن ما حصل هو العكس.
إن استعادة عملية السلام في الشرق الأوسط لدى السلطة الفلسطينية الآن، لا يبدو أمراً مهماً في هذه المرحلة بالذات. خاصة في ظل استمرار الاستيطان وزيادة وتيرته، ومن ناحية أخرى سعيها نحو الأمم المتحدة، لكسب التأييد لدى منظماتها بالاعتراف بها كدولة.
لكن إذا ما تهيّأت الظروف كاملةً، لمواصلة العملية التفاوضية، القصد منها التوصل إلي حل نهائي وشامل، فيجب إن يؤخذ بالاعتبار رضا الجانب الفلسطيني في جميع مطالبه، إما أن يبقي الضغط الدولي مسلطاً على الطرف الأضعف، وهم الفلسطينيون والعرب، وتُوجّه لقادتهم تُهم العقبة في وجه السلام، وأخرى للمقاومة تتعلق بالإرهاب، فهذه لن تحسم الخلافات القائمة، مهما كانت دقة العمليات التجميلية للفكرة التفاوضية، وسيظل كل شيء يُراوح مكانه، لأن القضية بالنسبة للفلسطينيين والعرب، هي إنهاء الاحتلال والقضاء على إرهاب المحتل.
لكن وكما يبدو وفي ظل حكومة إسرائيلية يمينية، وضعت قضية السلام في آخر سلم أولوياتها، فإن الأمر يستلزم، وقفة جادة أولاً من قبل المجتمع الفلسطيني، لإنهاء حالة الانقسام، ومن ثم التطلع إلى الدور العربي القادم، الذي من شأنه لملمة الجهود، التي ترمي إلى تنشيط الدور الدولي وخاصةً الولايات المتحدة، باعتبارها الطرف الأكثر فاعلية في التأثير، وفرض الحل على الطرف الإسرائيلي، ليس من قبيل احترامها للعرب وتأييدها للفلسطينيين، ولكن لأجل مصالحها المصيرية، وسواء الحالية أو المستقبلية، أما أن تظل المخاوف الأمنية الإسرائيلية "الأكاذيب" هي المسيطرة طوال الوقت، وتُهمل المطالب الفلسطينية، إسرائيلياً وأمريكياً، فذلك لن يزيد الأمر إلاّ تعقيداً، وتكريساً للصراع، وعندها لن يثنِ من عقد العزم على مقاومة الاحتلال بصوره ومعانيه، عن أن يظل يقاوم عدواً، لا يدفع الحق إلاّ حتف أنفه، وإن طال الزمن.

























